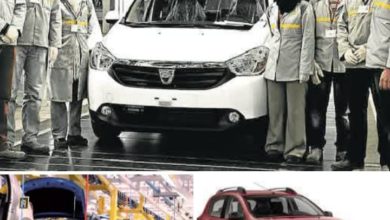الطلاق الاتفاقي يرتفع بالمغرب… تحوّل ثقافي أم هشاشة في العلاقات الزوجية؟
الرباط: إدريس بنمسعود
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مؤشرات مقلقة بشأن واقع الأسرة المغربية، إذ تجاوز عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بمحاكم المملكة خلال سنة 2024 حاجز 178 ألف قضية، بمعدل 488 حالة يومياً. وتوزعت هذه القضايا بين 134 ألفاً و683 ملف تطليق، و43 ألفاً و607 ملفات طلاق، فيما بلغ عدد الملفات المحكومة 150 ألفاً و263 ملفاً. وتظهر الأرقام أن الطلاق الاتفاقي بات يشكل أكثر من 96 في المائة من مجموع حالات الطلاق، في تحول اجتماعي يعكس انتقال المجتمع من النظر إلى الطلاق كوصمة، إلى اعتباره حلاً توافقياً لتفادي الصدام وحماية ما تبقى من الروابط الإنسانية.
ويرى الباحث في قضايا الأسرة محمد حبيب، أن هذا التحول يعبر عن نضج نسبي في الوعي الحقوقي، إذ يختار كثير من الأزواج اليوم إنهاء العلاقة في هدوء بعيداً عن العنف والتجريح، بما يحافظ على كرامة الطرفين ويحمي الأبناء من دوامة النزاعات الطويلة. غير أن هذه النسبة المرتفعة، على إيجابيتها الظاهرية، تخفي في عمقها هشاشة عاطفية وضعفاً في مهارات التواصل الزواجي، فالكثير من الأزواج يفضلون الانفصال السلمي بدل مواجهة جذور الخلاف والسعي إلى إصلاحها. وهكذا يتحول الطلاق إلى هروبٍ من المواجهة بدل أن يكون محطةً لتصحيح المسار.
أما بخصوص قضايا التطليق، فقد بلغت أكثر من 134 ألف قضية، 97 في المائة منها بسبب الشقاق، وهي نسبة تكشف عن نوع جديد من العلاقات الزوجية يغيب فيها الحوار الحقيقي لتحل محله المساطر القضائية. فحين يلجأ الزوجان إلى المحكمة لتدبير حياتهما الخاصة، فهذا يعني أن المجتمع فقد وسائطه التقليدية في الإصلاح، من كبار العائلة والوجهاء، ولم يعوضها بعد بمؤسسات حديثة قادرة على احتواء الخلافات. ويشير الباحث إلى أن هذه الظاهرة يمكن تفسيرها أيضاً من منظور نفسي واجتماعي، إذ ترتبط بارتفاع الضغوط الاقتصادية والنفسية وتزايد التوقعات غير الواقعية بين الزوجين، ما يجعل الزواج نفسه محفوفاً بالتحديات ويضع العلاقة تحت ضغط دائم.
ويبرز في هذا السياق الدور الحيوي للمساعد الاجتماعي داخل محاكم الأسرة، والذي يرى فيه محمد حبيب عنصراً إنسانياً أساسياً، لأنه يصغي إلى الألم قبل أن يُصدر القاضي الحكم، ويفهم الأبعاد النفسية والاجتماعية للنزاع التي لا تظهر في الوثائق. فالمساعد الاجتماعي، كما يصفه، هو جسر بين القانون والإنسان، بين النص والمشاعر، ويمكن أن يتحول إلى فاعل حقيقي في الحد من نسب الطلاق إذا أُعطي التكوين اللازم والإمكانات الكافية. كما يشدد الباحث على أهمية تأسيس منظومة متكاملة للوساطة الأسرية داخل المحاكم، تُمكّن الأزواج من استعادة القدرة على التواصل قبل أن يتحول الخلاف إلى قطيعة نهائية.
ويستشهد محمد حبيب بتجارب دولية، مثل فرنسا وكندا، حيث لا يُقبل طلب الطلاق إلا بعد المرور بجلسات وساطة يشرف عليها مختصون في علم النفس والاجتماع والقانون، وقد أظهرت التجارب أن نصف الأزواج تقريباً يتراجعون عن قرار الانفصال بعد خوضهم هذه المرحلة، لأنها تمنحهم فرصة للإصغاء المتبادل وإعادة التفكير. ومن هذا المنطلق، يرى أن المغرب في حاجة ملحّة إلى اعتماد مقاربة وقائية داخل محاكم الأسرة، عبر مراكز وساطة بإشراف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبشراكة مع المجتمع المدني، يكون هدفها ليس فقط الصلح بل ترسيخ قيم الحوار والمسؤولية المشتركة.
ويؤكد الباحث أن الأرقام المعروضة لا تعكس مجرد ارتفاع في معدلات الطلاق، بل تكشف عن تحول ثقافي عميق في تصور المغاربة للعائلة والزواج، حيث لم يعد يُنظر إلى الزواج كرباط مقدس لا يُمسّ، بل كعلاقة تقوم على التوازن والاختيار والقدرة على العيش المشترك. ومع ذلك، فإن كثرة حالات الطلاق تدل على أن المجتمع لم ينجح بعد في بناء آليات وقائية فعالة، وأن الإصلاح غالباً ما يأتي متأخراً بعد أن تتحول المشاعر إلى ملفات والبيوت إلى قاعات جلسات. لذلك، فإن المطلوب اليوم هو الانتقال من منطق “التقاضي بعد الفشل” إلى منطق “الوقاية قبل الانهيار”، عبر تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع، بين المدرسة والإعلام، وبين القاضي والمساعد الاجتماعي. فالمجتمع الذي ينجح في الإصلاح أكثر من الفصل هو الذي يحمي أبناءه من تكرار الأخطاء، ويبني جيلاً يعرف أن الحب مسؤولية قبل أن يكون شعوراً، وأن التواصل علاج قبل أن يصبح قضية أمام المحكمة.